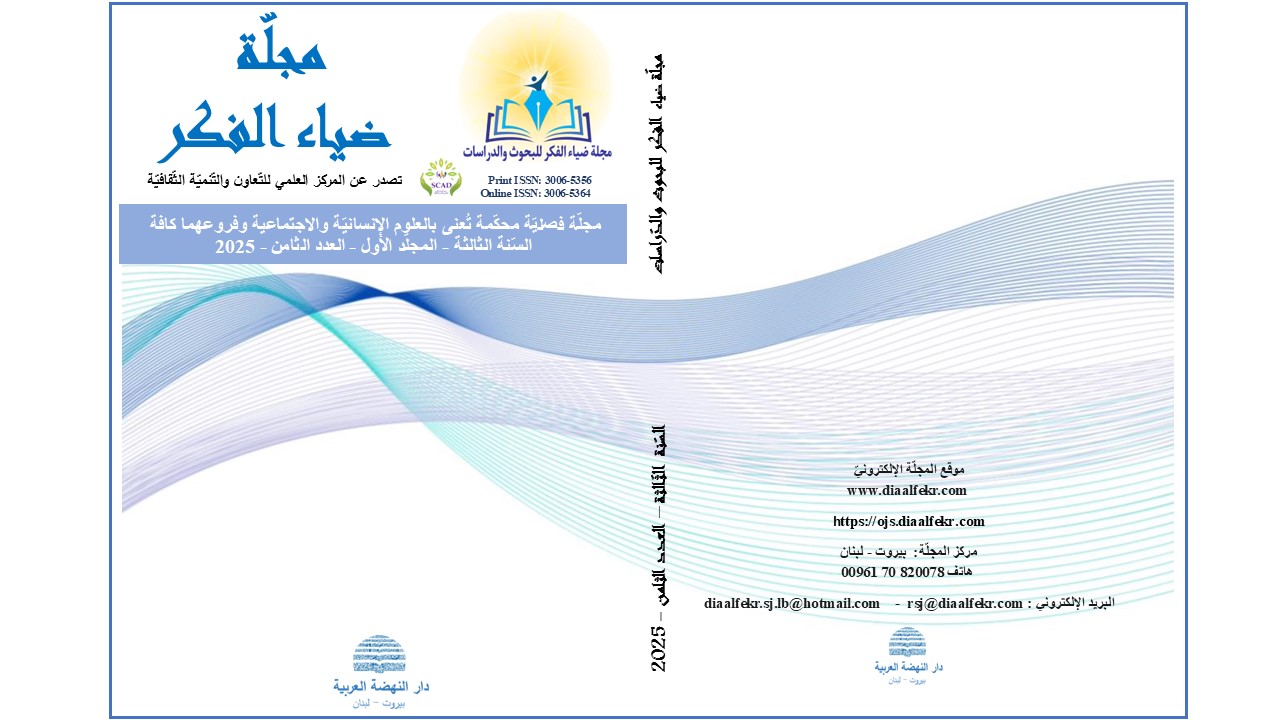الذّاكرة ودورها في عملية التّعلم
DOI:
https://doi.org/10.71090/gzbqr796الكلمات المفتاحية:
الذّاكرة، التّعلّم، التّعليم، الهويّة، التّذكّر، الخبرات الحياتيّة، التّلقين، التّعليم التّفاعليالملخص
تُعدّ الذّاكرة واحدة من أكثر القدرات الذّهنية غموضًا؛ فهي ركيزة من الرّكائز الأساسيّة التي تُبنى عليها هويتنا، وتجاربنا الحياتية ومعارفنا. من دون الذّاكرة، يفقد الإنسان ارتباطه بماضيه، وقدرته على التّعلم من تجاربه، والتّخطيط لمستقبله، ليصبح سجينًا في لحظة حاضر أبديّة معزولة.
ولأهميتها استحوذت الذّاكرة على اهتمام الفلاسفة والعلماء على مرّ العصور. فمنذ تأملات أرسطو حول طبيعة التّذكر، وصولًا إلى الأبحاث العصبيّة الحديثة، ظلّ السّعي لفهم آليات عمل الذّاكرة دافعًا رئيسًا للبحث العلمي.
الذّاكرة وعملية التّعلم، عنوان يفرض علينا تساؤلات كثيرة، منها:
لمَ الجمع بين المفهوميْن في عنوان واحد؟
وهل الدّمج بينهما ضرورة ملحة؟
وهل هناك عملية تعلّم من دون خبرات متراكمة، وسلوكيات محفورة، وقيم محفوظة؟؟
وكيف يمكن للّتعليم أن يكون من دون تنقيب، وتفكّر، واسترجاع، وتقييم، وتقويم؟
وهل يمكن للمعلم أن يتجاهل الذّاكرة؟؟ وخاصة هي الجسر الذي نعبر به من التّجربة إلى الفهم، ومن المعلومة إلى المعنى؟ فالذّاكرة ليست مجرد سجلٍ لمحطاتٍ عبرناها، بل هي الوقود الذي نحتاجه لنكمل مسيرة التّعلم، فهل يمكن أن نعلم من دون أن نستنير بما خزّنّاه؟؟
سيعرض البحث دور الذّاكرة في عمليتي التّعلًم والتّعليم، وكيف يمكننا استغلال المهارات والعادات اليومية في تحسين عمل الذّاكرة. إضافة إلى أهمية التّعاون بين الأهل والمعلم، ودورهما في إغناء عمل الذّاكرة؛
وسيؤكّد أنّ جودة التّعليم لن تتحقق إذا اقتصر أسلوب التّعليم على التّلقين، بل سيتحقق عندما تتوفر أساليب وطرق تهدف إلى تحقيق المشاركة والارتباط بين المعلم والمتعلمين ضمن توجيهات المعلم، ممّا يؤدي إلى بيئة تعلّمية- تعليميّة سليمة.